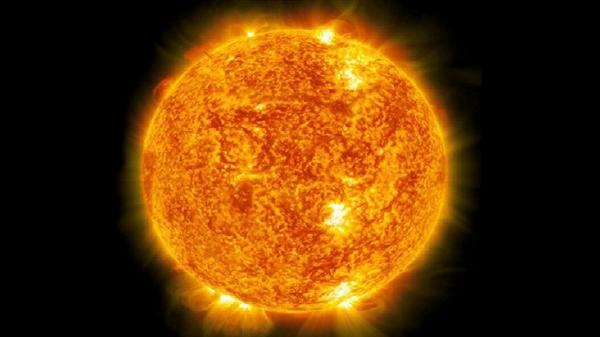مخرج “ستموت في العشرين” أمجد أبو العلا: كنت أعلم أنه سيرشح للأوسكار

(ستموت في العشرين).. يحكي الفيلم المقتبس من قصة للروائي السوداني حمور زيادة بعنوان “النوم عند قدمي الجبل”؛ قصة الشاب مزمل الذي تنبأ له عرّاف بالموت في العشرين. تزامن عرض الفيلم مع الثورة السودانية التي أطاحت بحكم البشير، وهي ثورة شارك فيها المخرج السوداني الشاب أمجد أبو العلا، لتمتد ثورته لعالم السينما، موقعا على شهادة ميلاد جديدة للسينما السودانية بعد تتويج فيلمه “ستموت في العشرين” بجائزة “أسد البندقية” و”نجمة الجونة”، ومثّل بلده السودان في جوائز الأوسكار.
في هذا الحوار مع الجزيرة الوثائقية يحكي المخرج أمجد أبو العلا عن تصوراته وتطلعاته في عالم السينما، وإرهاصات عمله الروائي الطويل الأول.
• كيف أثر المخرج يوسف شاهين في قرارك دخول عالم السينما؟
لقد كان للمخرج الكبير يوسف شاهين تأثير كبير في دخولي لمجال صناعة الأفلام، لأنه جعلني في عمر صغير أختار السينما التي أحب، حيث بدأت أُقارن وأنا صغير السن بين السينما التي ينتجها يوسف شاهين والسينما التي يحبها الناس، وقد لاحظت أن لدى الناس قدرة على التعرف على أعمال يوسف شاهين من خلال مشاهد قصيرة. حينها انتابني فضول للتعرف على هذا المخرج الذي يستغرب الناس من أعماله، ولديهم القدرة على التعرف على لمسته، فبدأت بمشاهدة جميع أفلام يوسف شاهين، واستوعبت أنني أمام حالة خاصة، حالة أريد أن أشارك في صنعها. قبل اكتشاف عالم السينما، كنت قارئا نهما للروايات ومهتما بالفنون عامة، وأظن أنني وجدت في يوسف شاهين كل ما أحب، فالرسم موجود في طريقة إخراجه، والموسيقى تشكل ركيزة في أفلامه، وهكذا بدأ اهتمامي بهذا النوع من السينما. وقد تطوّر الأمر لا شك بعد يوسف شاهين للاكتشاف والانفتاح على مخرجين آخرين، مثل اليوناني “ثيو أنجيلوبولوس”.
• ترعرعت في أسرة محافظة رفضت فكرة دراستك السينما، كيف تحايلت على هذا الواقع؟
لا بالعكس، فقد ترعرعت في أسرة منفتحة سواء من طرف الوالد أو الوالدة، وقد ولدت في الإمارات، وقضيت فترة من طفولتي في السودان في بيت جدي، بل حتى إن جدي من الأسماء الشيوعية المعروفة في السودان. وككل الأسر العربية فهم ينظرون للفن بشكل جميل، لكن كهواية وليس كمجال دراسة وعمل، فقد واجهت بعض الصعوبات ليتحمسوا من أجل دراستي السينما في فرنسا، فلم تكن لديهم قناعة كافية بأن الفن يستحق كل هذا الاغتراب والمصاريف، وفضلوا أن أدرس بمكان قريب منهم، وفي الإمارات تحديدا حيث درست الإعلام. لكن بطريقتي تحايلت على التكوين، واستطعت دراسة الإعلام بأسلوب سينمائي عبر تكوين فريق سينما داخل الجامعة، والسيطرة على كاميرا قسم الإعلام، وبدأت رفقة أصدقائي في تصوير ما يقارب 12 فيلما في أربع سنوات، وشاركنا في مهرجانات عربية، فصنعت شخصيا أربعة أفلام كمخرج، وأعمالا أخرى كمنتج.
• هل كنت تدرك في طفولتك وبزوغ اهتمامك بالسينما واقع السينما السودانية والمنع الذي كانت تحت وطأته؟
بالتأكيد في طفولتي لم أكن واعيا بهذا التفصيل، لكن كان دائما لدي سؤال لماذا لا نملك أفلاما كالتي نحبها في السينما المصرية؟ تحديدا هذه المقارنة بين مصر والسودان دائما واردة بحكم القرب الجغرافي والانتماء لجذور واحدة، خصوصا أن جدي من صعيد مصر. أظن أنني كنت دائما في حالة مقارنة، ومع مرور السنوات بدأت أستوعب فكرة المنع، وبدأت ألتقي مع المخرجين الذين كانوا يعملون قبل المنع ورأيت إحباطهم. فبقي لدي شيء واحد، هو كيف نفك هذه المعضلة، أظن أنني عملت على هذا الحل لمدة عشرين عاما، منذ أن دخلت الجامعة وأنا أعيش على فكرة أن أنجز فيلما سودانيا مهما. لقد عملت لهذه اللحظة عشرين عاما، وكنت أتحدث بصوت عال مع من حولي بأنني سأنجز فيلما طويلا ناجحا، وبالتالي حتى حينما يسألني شخص ما حول ما إن تفاجئت بنجاح “ستموت في العشرين”، في الحقيقة لا، عندما تخطط لشيء فإنك لا تتفاجئ به، وأنا خططت لفكرة صناعة فيلم سوداني عالمي بكل الطرق، من دراسة الإنتاج إلى التكوين الفني والذاتي.
• نجحت في صناعة أفلام متحديا غياب الدعم والتكوين وكل أساسيات التصوير، ما هو تعريفك للسينما إذن؟
لقد درست جيدا عدة سنوات، وساعدني في ذلك وجودي في المهرجانات العربية للأفلام القصيرة كمشارك وحتى كمبرمج، ساعدني ذلك في دراسة فكرة الإنتاج المشترك، وكان واضحا أنه هو الحل في غياب الدعم المحلي. درست شكل العقود والعلاقات بين الأطراف المختلفة، واستفدت أيضا من وجودي في المحافل السينمائية والورشات، وكذلك عن طريق التعليم الذاتي، ومن ضمن الورشات المهمة التي أخذتها في حياتي ورشة مع المخرج الكبير الإيراني عباس كيارستمي عام 2012، وخرجت منها بفيلم قصير بعنوان “أستوديو” بإشراف من عباس كيارستمي، فقد أشرف معي على النص والتصوير والمونتاج، وبالتالي تتلمذت على يد العظيم كيارستمي، وبعدها بسنوات شاركت في ورشة للكتابة السينمائية مع المخرج الإيراني أصغر فرهادي. تعريفي للسينما أنها مرآة المجتمع والشعوب، السينما ذاكرة، تخيّل بعد ألف عام ستبقى هذه الأفلام كذاكرة لشعوب أخرى ولأحفادنا عن ما كنا نعاني منه الآن والأشياء التي تشغلنا، السينما مرآة وذاكرة ووسيلة لطيفة للحكي، أرى أنني عندما أكون في مهرجان سينما، وأنتقل من فيلم بوسني إلى فيلم صربي لفيلم هندي؛ فأنا فعلا أمتطي جوادا يقفز بي بين الدول، السينما شبابيك.
• الشاب مزمل بطل فيلم “ستموت في العشرين” والذي تنبأ له عرّاف بالموت في العشرين من عمره في فيلمك “ستموت في العشرين” يظهر أنك متأثر بالسينما الواقعية، هل هي اختيار إخراجي، أم بسبب ظروف التصوير في السودان؟
ليس بالضرورة، فأنا أتعامل مع كل فيلم حسب حكايته، وأنا أحب السينما بأشكالها المختلفة، وأرى نفسي أصنع السينما مستقبلا بأشكال مختلفة.
• هل “ستموت في العشرين” غارق في الواقعية؟
أرى أنه كان هناك جزء كبير يعكس الميتافيزيقية، وهو شيء لا يمكن تصويره في السينما الواقعية، مثلا مشهد موت سليمان وظهور الحصان فجأة عند النافذة. أظن أنني أحب السينما الواقعية لكني غير ملتزم بها، وأحب أيضا السينما السريالية، ومن أهم المخرجين الذين أحبهم المخرج “أندري تاركوفسكي”، فإلى أي مدى يمكن اعتبار “تاركوفسكي” واقعيا أو سرياليا، وهذه هي السينما التي أحبها. لكن العصر الحالي واقعي جدا، فحتى إن كنت أحب هؤلاء السينمائيين الغارقين في الشاعرية، فهناك واقعية محيطة بي وأعيشها لا تسمح لي بأن أكون مخرجا شاعريا يعيش في برجه العاجي، أحب أن أكون على الأرض ويلامس فيلمي الكثير من الناس.
• البطل مُزمل رفقة والدته سكينة التي تلبس السواد، وتقضي أيامها تحصي ما بقي لابنها “مزمل” من عمر فيلمك مقتبس من قصة “النوم عند قدمي الجبل” لحمور زيادة، ما السبب الذي جعلك تجد في هذه القصة سردا سينمائيا يستحق أن يُحكى؟
كنت أبحث عن القصة التي من خلالها أستطيع أن أعكس ما أريد قوله عن السودان والفرد السوداني، أعتقد أن هناك تكثيفا للحالة السودانية في القرى، هناك تواجد مكثف للجذور والأصول في القرى السودانية، على عكس المدن التي تشهد تنوعا واختلاطا، فإن أردت قول شيء عن هذا المجتمع فالقرية هي المكان الأمثل لنقل ذلك. هذا ما وجدته في حكاية قرية يُولد فيها طفل بنبوءة موته عند بلوغه سن العشرين، وبالتالي كان مناسبا أن أُحمل بطل فيلمي مزمل كل ما أردتُ قوله للمواطن السوداني الخاضع للعادات والتقاليد، وما يترتب عن ما بعد الأديان لا الأديان نفسها، وجدت في مزمل الحل المناسب لمناقشة الإنسان السوداني. أُحب الأفكار المبنية على “ماذا لو؟”، فماذا لو قيل لأحدهم إن لديه عشرين سنة للعيش، أهمية القصة بالنسبة لي هي “ماذا لو؟”.
• كيف أثرت الثورة السودانية في فيلمك “ستموت في العشرين”؟
الثورة السودانية أثرت بعدة طرق في الفيلم، مبدئيا كنا في حالة ثورة منذ 2013 لغاية 2019، وكان هناك حراك سياسي يُسمى “حراك سبتمبر” فقدنا فيه 250 شهيدا. أظن أن الغضب في تلك اللحظة وعدم قدرتنا على القيام بثورة ناجحة خلال الربيع العربي، خلق نوعا من التمرد الفني والشعبي عند النشطاء السياسيين، وساعدنا في ذلك انهيار العملة وانهيار النظام داخليا من خلال خلافاته الخاصة التي بدأت تفككه، كنا نثور منذ تلك الفترة حتى لو لم تكن ثورتنا ظاهرة. بالنسبة للفنانين، سترى أنه في السنوات الأخيرة انتشرت الغرافيتي في الشوارع وانتشرت الأغاني. أظن أننا كنا أنا وصهيب الباري ومروى زين، كل على حدة يُجهّز لفيلمه لسنوات، فأرى أن الثورة أثرت حتى في اختياري للقصة والطرح المطروح على مزمل، وكأني أقول له اخرج من الصندوق وانتفض. الفيلم كله يدعو للانتفاضة، ولم أتصور للحظة أن أول يوم في تصوير الفيلم هو أول يوم في الثورة التي اندلعت شرارتها في مدينة أخرى تبعد ست ساعات عن مدينة مدني التي كنا نصور فيها الفيلم، فصورنا الفيلم بهذه الروح الثورية لمدة شهر كامل من التصوير، كنا نعود فيها للفندق لمتابعة أحداث الثورة. بعد ذلك تواصلت الثورة في الشوارع، وأنا حينها كنت قد أنهيت الفيلم ورحلت إلى القاهرة من أجل المونتاج، لكن كانت الدعوات للاعتصام الأكبر في السادس من أبريل ، فوجدت نفسي دون علم المنتجين أشد الرحال للسودان من أجل المشاركة في الاعتصام. جلست في الميدان لمدة شهرين أنام في الشوارع، وعدت إلى القاهرة لاستكمال المونتاج قبل وقوع مجزرة في الاعتصام، هذا الحدث جعلني غاضبا بشدة، وانعكس الأمر على المونتاج، حتى أنني غيرت طريقة القطع وصار حادا جدا، هذا الغضب انعكس أيضا حتى على اختياراتي الموسيقية مع الموسيقار أيمن بوحافة.
• ترافق عرض فيلمك “ستموت في العشرين” مع عرض الوثائقي السوداني “الحديث عن الأشجار” للمخرج صهيب الباري، جاءت أعمالكم كشعلة أمل للفن في السودان، فهل تعتقدون أن نجاح أعمالكم مدين للثورة؟
عُرض فيلم “الحديث عن الأشجار” لصهيب الباري في مهرجان برلين، وفاز بجائزة الجمهور، وجائزة أفضل فيلم وثائقي، وعُرض أيضا الفيلم الوثائقي “أوفسايد الخرطوم” للمخرجة مروى زين في المهرجان نفسه، وفي الفترة التي كانت الثورة قد اندلعت فيها، وفي الفترة التي كنت أعمل فيها على المونتاج في القاهرة. أرى أن هذين الفيلمين -بالإضافة للثورة- بشارة خير للسينما وللسودانيين في الثورة ولي أنا بالذات، خصوصا أن فيلم “الحديث عن الأشجار” يتحدث عن غياب السينما السودانية، وأنا في غرفة المونتاج أصنع فيلما سينمائيا سيعوض كثيرا، أظن أننا شكلنا شعلة أمل للفن في السودان، خصوصا أن هذا جاء بعد شعلة أمل سياسية في التخلص من النظام القديم والانتقال لنظام ليبرالي. أفلامنا بالنسبة لكثيرين تعبير عن مرحلة جديدة، ولو أننا اشتغلنا عليها منذ فترة النظام القديم وما شكله من صعوبات لاستخراج التصاريح بأشكال ملتوية، وكنا تحت رقابتهم ونحن نصور، حتى أن الثورة شغلت السلطات عن مراقبتنا ونحن نصور فيلمنا.
• المخرج السوداني أمجد أبو العلا رفقة فريق عمل فيلمه “ستموت في العشرين” بعد فوزهم بجائزة “أسد البندقية” قررت صناعة فيلمك حتى قبل انطلاق الثورة، كيف قررت إذن صناعة فيلم سوداني في فترة كانت السينما السودانية تتجه فيها نحو الانقراض؟
أرى كفنان أن هناك جانبا شخصيا في الاختيار، لا يجب أن تكون كل تصرفات الفنان مرتبطة بالبلد. أنا كسينمائي لا أفهم الحدود كثيرا، لا أنظر لنفسي كسوداني أو إماراتي أو مصري، أنظر لنفسي كأمجد الذي يحب السينما، يشاهدها طوال عمره، ويريد أن يصنع فيلمه السينمائي الطويل الأول ببساطة. أظن أن صناعتي للفيلم فيها جانب شخصي مرتبط برغبتي في إنجاز مشروع شخصي، وبالتأكيد كان بإمكاني أن أصنع فيلما مصريا أو بأي جنسية أخرى، لكن خيار صناعة فيلم سوداني كان الخيار الأقوى بداخلي، بالتالي فقد تداخل العام مع الخاص. كنت أعلم أن المعركة كبيرة، وكنت سأتعرض أنا للانقراض بسبب الضغط أثناء التحضير والتصوير والتأجيلات، وتعرضت لمشاكل صحية بسبب كل هذا، لدرجة أن الطبيب وصف لي أدوية مضادة للضغط، وأوصاني بالانتهاء من تناولها بعد انتهاء العمل على الفيلم، وفعلا ذلك ما حصل، لذلك أظن أن فيلمي والأفلام الوثائقية التي أُنتجت ذلك العام أعطت قبلة حياة للسينما السودانية.
• عند الانتهاء من مونتاج الفيلم، ما هي أبعد نقطة كنت تعتقد أنه سيصلها، وهل كنت مدركا أنك صنعت أهم فيلم في تاريخ السودان؟ لا أعلم كيف أجيب عن هذا السؤال بدون أن يظهر أنني واثق زيادة عن اللزوم من نفسي، لكن هذه حقيقة، أعددت لهذه الخطوة لمدة عشرين عاما، لقد كان واضحا من اسم الفيلم أن هناك من سيفتح عينيه للفيلم، وينتظر ما الذي يخفيه هذا العمل. في علم التسويق هذه بداية جيدة، لم نتعب في البحث عن منتجين من شدة حبهم للقصة وإيمانهم بها. عند تصويري للفيلم كنت مدركا أن العمل سيصل لمهرجان كبير، لم يكن لدي شك ولا تخوف، فقد كنت أعلم أنه سيرشح للأوسكار، حتى في ظل النظام السابق، لأن الترشيح للأوسكار وتمثيل البلد يكون من اختيار الدولة. هذه الثقة أيضا هي نتيجة عملي في المهرجانات، وكانت لي قراءاتي للخريطة السينمائية عموما، وكانت لي القدرة على تقييم فيلمي عن بُعد كأنه ليس فيلمي، هذا أيضا سبب لتوقعاتي حول الفيلم.
• هل ترى أنك بدأت موجة جديدة في سينما السودان، وما هي خطوتك المستقبلية للنهوض بسينما البلد؟
أرى أننا بدأنا موجة سينمائية جديدة بالسودان، بدأنا بحماس معين، لكن لا أستطيع أن أتنبأ أن هذا يمكن أن يستمر بشكلٍ مستقر، إلا إن كانت هناك صناعة سينمائية، حتى الآن كل هذا عبارة عن محاولات فردية، والمحاولات الفردية لا تصنع صناعة سينمائية. أتمنى أن تهتم الدولة بدعم صناعة سينمائية مستقرة، وذلك يحدث بالتدريب، وبدعم أنواع مختلفة من السينما، معامل للتدريب وورشات قد تضمن أن تستمر السينما. حتى الآن كل المحاولات السينمائية بالبلد هي محاولات شخصية، والدولة تنتظر أن نفعل ذلك لتهنئنا، ولا تعلم أنها يجب أن تكون فاعلا في الصناعة السينمائية، كذلك على رجال الأعمال أن يستثمروا في الفن.
• ما هي نصيحتك لشبان بلدك الذين يريدون دراسة السينما والعمل فيها، لكنهم لا يجدون مراكز للتكوين؟
أنصح الشباب أن يعملوا على الضغط على الدولة لإنشاء مؤسسات سينمائية، والعمل على أنفسهم في الوقت نفسه دون انتظار الدولة، الضغط نعم، لكن في الوقت نفسه عدم الانتظار. نحن الآن في عالم مفتوح، أنصح الشباب المُحبين للسينما أن ينطلقوا نحو العالم إن تمكنوا من ذلك، للمشاركة في الورشات وزيارة مواقع التصوير وعدم الانتظار.
• في الختام، هل يمكنك أن تذكر لنا الأفلام والمخرجين الذين أثروا في أسلوبك السينمائي؟
فيلمي “ستموت في العشرين” كان مليئا بإشارات وتحيات حب لمخرجين كثر أثروا في مساري، عبر استلهام مشاهد بشكل مقصود من أفلامهم، خصوصا أن فيلمي يحتوي على تحية للسينما، من خلال شخصية سليمان الذي استعمل السينما كشباك، ليُظهر لمزمل أن هناك عالما آخر بعد النيل. فكرة إدراج هذه التحيات هي وسيلتي لشكر المخرجين الذين تعلمت السينما عن طريق مشاهدة أفلامهم، مثل يوسف شاهين، ووجود فيلمه “باب الحديد” في فيلمي، والمخرج السوداني صاحب آخر فيلم أنتج في السودان قبل عشرين عاما جاد الله جبارة، وأيضا المخرج شادي عبد السلام وفيلمه “المومياء”، وتحديدا مشهد دخول مزمل كبيرا وصغيرا، كان محاكاة مقصودة لتحية شخصية صلاح مرعي بطل فيلم “المومياء”، وكذلك المخرج “ثيو أنجيلوبولوس” في “المرج الباكي” (The Weeping Meadow)، وهناك أيضا تحية للمخرج “تاركوفسكي”، وفكرة إدراجه للحصان في مشاهد يصعب دخول الحصان فيها، وهو ما قمت به في مشهد موت سليمان الذي مات في الكرسي كتحية للمخرج أسامة فوزي الذي رحل قبل تصوير المشهد بـ12 ساعة، واقتبست مشهد الموت من فيلمه “جنة الشياطين”. عموما أنا مشاهد نهم للسينما، لذلك أعشق مخرجين من مناطق مختلفة حول العالم، أنا عاشق للسينما عموما.
السوداني